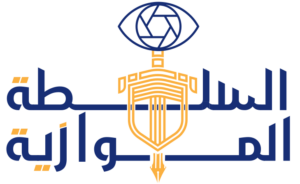كيف دخلت التلفزيون الوحيد؟ الحلقة 1
مصطاف محمد عمار/ مستشار بوزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية

قبل العام 2011 لم يكن لدينا الشيء الكثير مما لدينا اليوم.
لم تكن لدينا هذه الوفرة التي أفقدت الكثير من الأشياء أهميتها، وقد أدرك القدماء خطورة ذلك مبكرا، ولأنه ليس بمقدورهم تغيير مجرى الحياة، جلس بعضهم على كثيب رملي متحرك وقال قولته الشهيرة:
” لعن الله الوفرة تفسد نكهة الندرة”
ونحن في موريتانيا:
كان لدينا قبل هذا التاريخ تلفزيون حكومي واحد، ظل هو المصدر الوحيد للأخبار الرسمية حتى اجتاحت الساحة تلفزيونات خاصة، جاءت بعدها الموجة الكاسحة لوسائل التواصل الاجتماعي، فمكنت إبني وابنك ذو الست سنوات، من سلاح خطير، بات يستخدمه كوسيلة مرعبة للتهديد بنسف العالم بالبذائة والتفاهات الطفولية.
المفارقة أن بعض الكبار بات يقلدهم، مستخدما نفس أساليب التفاهة، لكن بلغة نفهمها، وبهذا كله لم يعد للتلفزيون سطوته بعد أن كان سيد عصره في السنوات التي سأحكي لكم عنها، تماما كما حكي لي يومها طبيب المسالك البولية المعروف الدكتور المصطفى ولد الشيخ عبد الله قائلا:
– يظل الشخص طبيعيا في أعيننا حتى نشاهده على الشاشة، فيتحول في مخيلتنا إلى إنسان غير عادي، ويظل كائنا غير عادي حتى نراه في الواقع، فيصبح شخصا عاديا.
فكيف دخلت التلفزيون إذن؟
الحلقة 1
كثيرا ما طرح عليَّ هذا السؤال سنة 2007، مع اختلاف في الصيغة والنبرة، بل وحتى المناسبة، ومع بداية 2008 بدأ السؤال يختفي تدريجيا، تاركا المجال لأمر واقع ظل البعض يتجرعه على مضض، فيما كان آخرون يستقبلونه بحبور.
أيمكن أن تكون صورتي على الشاشة الصغيرة مصدرا لكل هذا الاستقطاب؟ كثيرا ما كنت أسائل نفسي.
ورغم أنني لم أجد يوما من يجيبني على هذا السؤال، فإن أطرف تعليق سمعته كان من رجل خمسيني نصف معاق من سكان الضفة.
قال لي الرجل – الذي كان يعمل بأحد استيديو هات التصوير الفوتوغرافي قرب ثكنة الحرس الوطني- ما نصه:
– عندما أشاهدك على الشاشة، أستعيد قوتي البدنية بشكل عجيب، لدرجة أنه يمكنني في تلك اللحظة تحمل أقوى ضربة على القفا من الملاكم الأمريكي مايك تايزن Mike Tyson
ضحكت كثيرا وشكرته، ثم أعربت له بود عن أسفي لعدم امتلاك فائض مالي يزيد على ثمن الصور الفوتوغرافية التي جئت لأجلها، فأعرب لي بدوره عن شكره على حسن نيتي، وأخبرني سرا بأنه صاحب ثروة من الأبقار ترعى على ضفتي النهر.
ذات مقيل من نفس السنة 2007 طرح علي النائب الموقر بيرام الداه اعبيدي نفس السؤال، عندما قابلته مرة رفقة الصديق القاضي محمد ولد بلال (كان حينها محاميا) في المقر القديم للجنة الوطنية لحقوق الانسان، في عهد مأمورية المغفور له محمد سعيد ولد همدي.
آخر مرة أذكرها كانت عندما سألني (ميشلان) ساخط في الداية 11 بمقاطعة عرفات، عندما قال لي بصفاقة غير مقصودة:
– كيف قبلوا بك على الشاشة، ومن دون أن ينتظر جوابي أضاف بحنق:
– لو كنت مكانك لما سمحت لهم أن يستخدموني لتلوين الشاشة.
صراحة لم أعرف هوية الأشخاص الذين كان يتحدث عنهم، وكنت حتى تلك اللحظة أعتقد أنني موظف بالتلفزيون، ودوري هو تقديم الأخبار التي لا لون لها.
من جه أخرى لم تكن لدي أدنى رغبة في الدخول معه في تلك المهاترات، وخرجت بخلاصة مفادها أن كثيرين مثله، كانوا سيطرحون أسئلة مماثلة لو أتيحت لهم الفرصة، فهذا حقه في التعبير، كما يحق لآخرين طرح أسئلة مغايرة والإدلاء بتعليقات تعبر عنهم.
حقيقة الأمر أنني لم أعرف حينها كيف أجيب على السؤال إجابة موحدة، لأن من كانوا يسألون حينها، كانوا يتوقعون إجابات مختلفة، وربما طرحه بعضهم دون أن يتوقع إجابة أصلا، فبعض الأسئلة أحيانا لا تحتمل إجابات، خصوصا إذا وجهت بصيغة استنكار.
بدوري، كنت أخمن خلفية السائل، فإذا ورد السؤال بصيغة استفسار يتوخى صاحبه المعلومة البريئة، أجبته بصيغة خبرية مهنية تماما، وإذا كان من “أولئك” أجبته بالنبرة التي لا تخلو من صلف:
– لقد دخلت التلفزيون من بابه الأمامي طبعا، تماما كما يدخل كل زائر.
وفي السياق ذاته، تبرع لي أحد العارفين – ممن كنت أجله- برأي يحتمل بعض التفسير، فقال لي بفرح مصطنع بينما كنت أستعد للمغادرة باتجاه الإمارات:
– أنا سعيد جدا بالتحاقك بهذا المركز الرائد في الشرق الأوسط، فمركز الإمارات للدراسات قلعة صعبة الولوج، ثم استطرد قائلا كمن يخاطب نفسه:
– إنها فرصة مهمة كي يتأكد المشككون من كفاءتك، أولئك الذين كان يغيظهم ظهورك على الشاشة، وظلوا يراهنون على فشلك.
أجبته وكنت ومازلت أحتفظ له ببعض الود:
– عزيزي مهدي، أشكرك على مشاعرك الأخوية، لكنني أؤكد لهؤلاء أنني لم أفكر يوما في مشاعرهم عندما كنت أنحت في الصخر بصمت.
وقبل أن أودعه قلت له مازحا أو جادا:
– يناسبني جدا استخدام لغة أهل الجبال، فأنا ابن عتيد لمدينة المجرية.
يتواصل