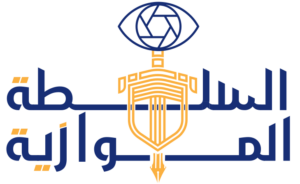أخبار وطنية
الصين تهدي لوزارة الشؤون الخارجية الموريتانية عشرات الأجهزة والمعدات المختلفة

السلطة الموازية– استلمت الخارجية الموريتانية، اليوم الثلاثاء، من نظيرتها الصينية، في العاصمة نواكشوط، هدية، تمثلت في 141 جهازمعلوماتي، وعدد من الكراسي المتحركة، وأدوات مدرسية.
ووقعت الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، العالية يحي منكوس، مع سفير جمهورية الصين الشعبيةفي موريتانيا، لي بيجن، وثيقة استلام دعم للوزارة.
وتضمنت هذه المساعدات كمية من الأرز و 50 ماكينة طحين، و 200 ماكينة خياطة،و 240 خيمة.
وحضر حفل التوقيع بمباني الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية ،ماصار سيسوقو السفير المدير العام لمديرية الدعم والوسائل المشتركة،وعدنان الشيباني السفير مدير آسيا وأقيانوسيا بالمديرية العامة للتعاون الثنائي، و عبد القادر أحمدو المدير العام للأكاديمية الدبلوماسية،إضافة إلى العديد من أطر القطاع.