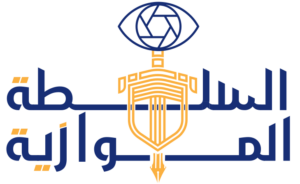هاجس التصنيع لدى الشعوب وهاجس الاستهلاك لدينا
خلال انتخابات ديمقراطية جادة في غانا، قدم أحد المرشحين برنامجًا انتخابيًا يتضمن وعدًا جازمًا بإقامة مصنع في كل دائرة انتخابية يزيد عدد سكانها عن ألفي نسمة. كان الهدف من ذلك تعزيز التكوين والتشغيل والإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال استغلال الموارد المحلية. وقد كان هذا الهاجس مشتركًا بين جميع المرشحين بصيغ مختلفة.
في المقابل، نحن هنا نعيش هاجسًا استهلاكيًا محضًا، حيث نتوجه إلى ما ينتجه الآخرون بجهودهم الذاتية وذكائهم. هذا الاستهلاك يعصف بالأموال العامة بلا رحمة، ويبدد مقدراتنا ببيعها للأجانب دون وازع من ضمير أو اعتبار للمستقبل. نحن، كأننا شعوب ساذجة، نعتبر أنفسنا محور الذكاء والتميز، بينما نغفل عن كوننا نعيش حالة من الغرابة والفقر الوطني. نشرب نخب الخطب الرنانة ونغمر أنفسنا في الشعر المخملي، لكننا نغفل عن العمل الذي يبني قواعد الإنتاج ويحقق الاستدامة.
نحن في هذا المنكب البعيد نتجاهل حاضرنا المتخلف عن ركب الأمم، ونتغافل عن المخاطر التي تهدد مستقبلنا، الذي يعاني من التفرقة وضعف البنية الاجتماعية. كل ذلك يحدث في ظل غياب روح الاستشراف وفتور إرادة التغيير بين سياسيينا المتصارعين، الذين يعتمدون على برامج خاوية وخطابات ضعيفة، وسط شغفهم للسلطة على حساب البناء الحقيقي للبلاد. وفي حين أن مثقفينا، إن كانوا كذلك، يتحلون بالنرجسية ويستحون من واقعهم، نجدهم يعيشون في حالة من الغموض المعرفي وضعف الأداء.
وفي ظل كل ذلك، يموت الوطن بلا دعائم صناعية أو روافع معرفية تحميه من أهوال الانحدار.
هل نحن إلا ما كنا؟
لا شك أن غفلة “السيبة” وشدة سطوتها ما تزال تقيدنا عن “المدنية” وسمو تعاملها، وعن التحضر وعمق لغته التخاطبية. ولعل التأكيد على هذا الأمر ليس بحاجة إلى جهد كبير أو تحليل معقد. فإضافةً إلى الترفع عن العمل الذي يتطلب أدنى جهد، هناك عزوف عن كل ما هو غير “الدراعة”، وتضخم “الأنا” في الحديث، وحب الاسترخاء، ورواية الأساطير، وقصائد المدح والهجاء، وكذب الغزل، وكثرة الطلاق والتفكك الأسري، والنفاق والغدر في العلاقات، والحربائية التي تعطل المسار السياسي وتخلق الأزمات السلبية، مما يتناقض مع البرامج التنموية والإصلاحية التي غالباً ما تكون غائبة عن الأذهان، وتفشل بسبب قصر النفس الوطني والجهل بوسائل وضع هذه البرامج وتمريرها والدعوة إليها.
كل هذه الصفات تجسد واقعاً مرا؛ نفاق وغدر وحربائية موجهة نحو الاستعلاء والادعاء. لقد أبقت هذه العقلية على ما كانت عليه قبل ظهور الدولة المركزية، متغاضية عن الظلم المستمر تحت كل جناح مرفرف للشر، متجاهلةً حقيقته وآثاره، حتى وإن توهمنا قدرتنا على التغطية. فالأثر أقوى من ضوء الشمس، وصداه أشد على النفوس من الحسام.
ولا يمكننا أن نتجاهل ما يعانيه سكان البلد من تباين صارخ بين قلة متخمة بالمال العام وذات هيمنة على الحياة الاقتصادية، وبين الغالبية الفقيرة التي تعيش في بؤرة من التخلف، محرومة حتى من تكوين طبقة وسطى. هذه الفجوة تجسد حالة لم تتبدل منذ ما قبل ظهور الدولة.
هل يسعى الصحفيون إلى المهنية؟
تابعت مرة فيلمًا وثائقيًا تم تصويره بكاميرا هاتف مخفية بطريقة ذكية ومهنية عالية. تجلت شجاعة الصحفية من قناة سباقة في توثيقها الدقيق للأحداث تحت وطأة رغبة “التنوير” وروح “المغامرة” الجريئة لتحقيق “السبق” الصحفي. تناول الوثائقي الحياة في إحدى الدول الآسيوية ذات الحكم الأحادي، مُظهرًا كيف يُعامل المواطنون في ورش العمل الكبرى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الاختلالات والمفارقات التي يعاني منها البلد وسكانه.
كانت الصور الملتقطة تعبر بوضوح عن مختلف جوانب الحياة، مرفقة بنص بسيط وعبارات بليغة لم تخلُ من التلقائية، مما جعلني أفهم الموضوع وأتفاعل معه. ولم تغفل الصحفية أهمية إجراء المقابلات كلما سنحت الفرصة، حيث كانت تتنكر أحيانًا كسائحة لتسهيل العملية.
متى يستطيع المهيمنون على إعلامنا أن يتجاوزوا التكلف والتقعر اللغوي والنثرية المفرطة، ويعيدوا تصوير الجمود على أنه جمال خالد؟ متى سيتوجهون في استطلاعاتهم وتحقيقاتهم إلى لب الموضوعات؟ وكيف يمكنهم تحسين انتقاء القضايا التي تستحق التغطية والعرض والنشر؟
هل يمكنهم ربط عملهم، الذي يتسم أحيانًا بالاستعجالية، بالوسائل المهنية العصرية واستخدام التقنيات الدقيقة، الخفيفة والسهلة الاستخدام؟ لا شك أن هناك العديد من الموضوعات الهامة التي يمكن للإعلام أن يتناولها، مما يُمكنه من الازدهار ولعب دوره الفعّال في الإخبار، المعالجة، الاستقصاء، التحليل والتنوير.
متى يعتمد أهل القطاعات مبدأ نقد الذات؟
على شاشة التلفزيون الرسمي لجمهورية ساحل العاج، تابع المشاهدون باندهاش وتعجب وإعجاب وزراء الحكومة وهم ينتقدون أداءهم، حيث أشاروا بوضوح إلى الاختلالات والنواقص التي تعاني منها بلادهم. جاء ذلك دون أي حرج أو محاولة للتملق، مع اعترافهم الصريح بالمراحل التي شهدت تأخراً في المشاريع. لقد اعترفوا بشجاعة بأن البنى التحتية في البلاد تحتاج إلى تحسين، مع التأكيد على ضرورة أن تراعي السياسات والبرامج المقبلة أسباب هذا التأخير وتحديد طرق المعالجة.
وزراء الحكومة هم أنفسهم الذين أكدوا، بوعي ونزاهة، أهمية تكليف خبراء مؤهلين، يتم اختيارهم بناءً على الكفاءة والوطنية، لإعداد الدراسات الفنية في المرحلة المقبلة. كما تم تكليف مختصين آخرين لمتابعة الإنجاز والأداء.
تشير المؤشرات إلى أن العديد من دول القارة، بما في ذلك ساحل العاج، حققت تقدماً ملحوظاً في إنجاز البنى التحتية الحيوية، مثل الطرق والسكك الحديدية والمشاريع التنموية. وهذه النهضة لم تكن لتتحقق لولا النقد الذاتي من المسؤولين، الذي أسفر عن تصحيح الأخطاء وأخذ الملاحظات بعين الاعتبار.
فهل يتبع المختصون في بلدنا هذا النهج، ويأخذون زمام المبادرة بشجاعة وطنية؟ هل يبتعدون عن الكراسي الوثيرة ليعملوا في الميدان، مقدّمين الملاحظات والنصائح التوجيهية اللازمة؟ وهل يفضلون بناء البنى التحتية بمعايير علمية على حساب الفساد والتواطؤ مع المكلفين بإنجاز الأعمال؟
بلاغة بناة وصمت عتاة
استقال أحد رؤساء الوزراء الفرنسيين ليعلن عن ترشحه لرئاسة الجمهورية، وارتجل كلمة مذهلة أظهرت تمكنه كسياسي مخضرم وعمق ثقافته. في هذا السياق، يتجلى عجز سياسيينا عن صياغة خطاب واضح، حتى وإن كان مكتوبًا، يعبر عن مضمون يفهمه الجميع.
كانت كلمة الوزير مفعمة بروح الوطنية، ومدعومة بإدراك عميق لمفهوم الدولة، ومعرفة واسعة بتطلعات الشعب الفرنسي. كما أظهر كامل الوعي بالتحديات التي تواجه فرنسا، والتي تهدد مكانتها، وتضعف إشعاعها، وتحاصر اقتصادها، وتقلص دورها على الساحة الدولية والأوروبية. بينما كان الواقع المر يبرز ضعف سياسيينا، الذين يفتقرون إلى مهارات الخطابة وفهم الهم الوطني، ولا يلمون بحقيقة التخلف القائم منذ نشأة الدولة، ولا بحاجتنا الملحة للانطلاق نحو تصحيح هذا الواقع ومعالجته.
غياب النخب المستحجرة عن صنع الأحداث
في دولة السنغال المجاورة، تشهد الساحة السياسية والثقافية والاقتصادية حركة ناضجة وعالية، حيث يظل حماس السياسيين والمثقفين والاقتصاديين والصناعيين والفنانين متقدًا. لا تكاد قاعات المؤتمرات وصالات العروض وفضاءات المعارض تخلو شهراً، إن لم يكن أسبوعاً، من تنظيم تظاهرات قارية وإقليمية ودولية متخصصة وذات شأن عام. وتعزز هذه الديناميكية من مكانة البلاد، وتوسع نطاق اهتمام المنظمات العالمية والمستثمرين، مما يجعل “السنغال” ورشة نابضة بالحياة، يستفيد منها الشعب في معاشه.
تسهم هذه الفعاليات في إغناء التجارب المتبادلة، حيث يستفيد السياسيون والمثقفون والفنانون من رؤى العالم، مستفيدين من قوتهم وإرادتهم القوية. لقد باتت هذه الحقيقة موضع تقدير من قبل مؤسسات وحكومات وشعوب العالم، حتى أصبح السنغال مضرب الأمثال وقبلة المثقفين والسياسيين والمستثمرين والسياح.
في العديد من المناسبات، افتتح الرئيس ملتقيات قارية ودولية، بحضور أطراف متعددة لمناقشة قضايا حيوية مثل الأمن والهجرة والطاقة والاقتصاد والمناخ. إن هذه التظاهرات ليست مجرد نشاطات دولية صحية ترفع من شأن الدول، بل تعكس نضج النخب وديناميتها، ورغبتها في الانفتاح والتبادل.
إذا نمت لدى الأفراد إرادة التحول، مع التخلص من غبار الكسل والرجعية الفكرية، فإن الوصول إلى مسار التحول المدني والتحضر سيكون مجرد مسألة وقت.
فهل ستخرج النخب الفاترة من قمقم الإساءة إلى البلد وتعريضه للزوال؟ وهل ستضطلع بدورها في صنع الأحداث، كلٌ في مجاله وتخصصه، إذا كان ثمة من ذلك فعلاً؟
المقاومة (الجهاد) بين المعاناة والمعاداة
بينما يفاخر بعض المتحيزين بالانتماء القبلي الضيق أو الشرائحي المبتدع، مثل البطل “ولد امسيكه”، بجهادهم “للمقاومة”، فإنهم يتجاهلون الطابع الوطني أو المرجع التاريخي الموثق الذي يجب أن يربط هذا الجهاد بالذاكرة الجمعية. في المقابل، يسعى البعض الآخر إلى إنكار وجود أو زخم هذه المقاومة، مستندين إلى شعورهم بالغياب والنقص في أدبياتها، دون أن يقدموا مبررات واضحة، سوى ردود فعل لفظية تفتقر للسياق.
من جهة أخرى، يبرز “باعة” انتفاعيون يستغلون تاريخاً مليئاً بالقلق والمجاملة، بعيدين عن البحث الجاد الذي يقيم الأحداث بشكل علمي. يسعون لكسب المال من السذج المتعطشين لصنع تاريخ موثوق لأجدادهم، حيث يمزجون بين الموضوعية والاختلاق، مما يؤثر سلباً على الوطن وأهله.
أما المناهضون، فيهدفون إلى نسف الماضي الذي يعتبرونه ظلماً لأجدادهم، زاعمين أن المقاومة لم تسجل في تاريخ البلد أي فقرات مشرقة. فمتى سيستطيع هذان التياران التوصل إلى موقف توافقي حول قيمة تاريخية مشتركة، في غياب مرجع مادي أو معنوي يحسم النقاش؟
من المعلوم أن معركة “أوسترليتز”، المعروفة أيضاً بمعركة الأباطرة الثلاثة، تعتبر من أهم المعارك في قارة أوروبا. وقعت في 2 ديسمبر 1805، بين قوات التحالف الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية الرومانية المقدسة من جهة، والإمبراطورية الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت من جهة أخرى. انتهت المعركة بانتصار حاسم للفرنسيين، مما جعل نابليون رمزاً للتاريخ والمجد الفرنسي. هذه المعركة تُروى دون تناقضات، حيث تُستحضر كتمثيل حي كلما استدعت الذاكرة الجمعية الفرنسية ذلك.
فهل نسلك الدرب الصحيح في فهم مقاومتنا وتاريخنا؟
الصناعة الرقمية والمعرفية
في وقتٍ نواجه فيه صعوبة في صناعة أبسط المنتجات مثل علبة كبريت أو قرص دواء، نجد أن رجال المال والنفوذ يودعون في البنوك المحلية والأجنبية عشرات الملايير من العملة الوطنية والأجنبية. هؤلاء يكتفون بمشاهدة ثرواتهم تتزايد دون أن يسهموا في بناء صناعة قوية تعود بالنفع على شعوبهم. بينما يتقدم العالم نحو الصناعات الرقمية والمعرفية، مستفيدين من الابتكار لدعم القوة الصناعية وتحقيق الرفاهية، نلاحظ أن بعض شعوب الدول المجاورة قد استشعرت هذا التوجه، وباتت تعمل بجد لتحقيق التنمية، بينما يبقى حراكنا محصورًا في قيم الفساد والنهب.
تمييع التراث وتدمير الميراث
إن ما يثير الدهشة هو تلك الإرادة المنفصلة عن القيم التاريخية، والتي تسعى إلى اختزال التراث العريق إلى ممارسات سطحية تفتقر إلى العمق الثقافي. هذه الممارسات تعكس انعدام الفهم الحقيقي للتراث، وتؤدي إلى أنشطة تفتقر إلى الروح الحقيقية التي تشكل نواة التاريخ. إن هذه الجماعات التي تفتقر إلى الحس الوطني تسعى إلى استغلال ضعف الدولة، بينما تظل النخب المثقفة بعيدة عن الوعي بضرورة حماية الهوية والخصوصية الثقافية.
كيف لنا أن نتجاوز تراثنا الغني في القيم مثل الفروسية والشجاعة، لنقع في فخ السلوكيات السلبية التي تعكس ضيق الأفق؟ هل من المعقول أن نصنع بنادق سريعة الطلقات ونعتبرها “رماية محلية” دون أن نعتمد على القيم والأساليب التي تعكس خصوصيتنا الثقافية؟
إن مخطوطاتنا، رغم أهميتها في تشكيل الهوية، لا تزال تحت هيمنة بعض الأطراف التي تستغلها لأغراض نفعية شخصية. في هذا السياق، يجب أن ندرك أن المقاومة الوطنية هي تراث مجيد، ينبغي أن يكون ملكًا للجميع، وليس وسيلة للتلاعب أو تفرقة الوحدة الوطنية من خلال قراءات مبتورة ومشخصنة.
مواكب مهيبة وأخرى كئيبة
في كل محطات زيارة “آدرار” خلال أيام الاستقلال، كان غياب شريحة “لحراطين” وباقي الشرائح الدونية شبه تام، وكأنها تلاشت من على أرض ولاية “آدرار” ووديانه التي يعتني سكانها بواحات نخيلها ويعكفون على حرث أراضيهم. هذا الغياب يثير تساؤلات: هل هو غياب مريب احتجاجي، أم نتيجة حتمية لإرادة “التغييب” التي يتبناها الأسياد “القدامى/ الجدد” والمالكون للإقطاعيات؟
بينما يشارك القلة من مفسدي المال العام والمبذرين في مواكب فاخرة، تعبر الفقر الذي تعاني منه البلاد، تبقى الساكنة المخلصة للمناسبة، تحتفل بزيّها المتواضع، مقدمة رسائل لرئيس الجمهورية، عساها تجد صدى لمطالبها وشكاواها من التهميش والعزلة.
متى نصلح ما بأنفسنا؟
لا شك أن العقلية “السيباتية” المستحكمة ما زالت تعيق تقدمنا. فهي في تناقض مثير، لا تترك مساحة تحرك كبيرة لأهل المعتقد الصحيح من علماء والأساتذة الأجلاء وأصحاب الخلق العظيم. ولأن هذه العقلية الفاسدة مسيطرة بلا رادع، نشهد ارتكاسات في المعاملات على خلفية قبلية تسيئ إلى القبيلة و”شرائحية” و”طبقية” تواصل إضعاف الدولة.
إن غياب العدالة يجعل من الصعب على الدولة أن تنهض، وهو غياب يعزز عزوف شرائح واسعة عن العمل والإنتاج، رغم امتلاكها الدولة لموارد كبيرة. وإن استمرارية هذه الوضعية السلبية تعكس فشل المجتمع في تغيير ما بالنفوس، وتؤكد على ضرورة مراجعة الأحوال لتتناسب مع قيم الاسلام العادلة.
رفض النخب التعاطي مع وسائل التغيير
في دول مثل السينغال ومالي وتونس والجزائر والمغرب، نجد إنتاجات سينمائية تعالج قضايا الفساد والنقص في الحكامات، مظهرة قدرة هذه الأمم على التغيير. ومع ذلك، نجد أن فنوننا لا تجد الدعم الكافي لتبرز، مما يضعف حركة النخبة التي تسعى للإبداع والتغيير.
إن هذه الوضعية تؤكد استمرار التخلف في ظل عقلية الشعب المتعصبة، والنخب الثقافية المستلبة والسياسية المتخاذلة، مما يعيق مسار التقدم ويؤكد الحاجة الملحة للانفتاح على الأفكار الحديثة وتعزيز روح المبادرة والإبداع.
ويح جيل الغد “المعاق” من جيل الحاضر “الهزيل”
صحيح أن الإرادة هي مفتاح النجاح، وأن النجاح هو غاية الوجود. ولكن، أمة لا يمتلك أبناؤها الإرادة لن تستطيع توقع النجاح، حتى وإن تظاهرت بالازدهار. فكما يكشف سفر الشمس إلى المغيب زيف السراب، يكشف واقع هذه البلاد، الذي يشبه هدوء البراكين النائمة، عن حجم الزيف المتجذر منذ الاستقلال عن مرحلة الفوضى.
تشهد البلاد أمواج محاكاة لعوالم خارجية تتراقص على سطح واقع جامد. هذا الواقع متخلف في تأويله، وعاطل عن الحركة عند محاولة استنطاق مجريات الأمور. فكل هذه المحاكاة ليست سوى زيف واحتيال لمن يتأمل الحقيقة بموضوعية.
نتائج هذه الحالة لا يمكن أن تبقى محجوبة طويلاً، حيث أن المشهد يعكس بصدق ما يحدث على الأرض. بعد ست وخمسين عاماً من الاستقلال، لا توجد بنى تحتية قادرة على إحداث تغيير، ولا كفاءات أو مخططين يرسمون ملامح المستقبل. بل، تعاني البلاد من غياب التوجيهات السياسية التي تحفز المواطنين على العمل والعطاء.
العقلية السياسية السائدة هي عقلية انتهازية تركز على المنفعة الشخصية، دون رؤية أو فلسفة واضحة. الشباب، بدورهم، يجدون أنفسهم كالأيتام على مأدبة اللئام، حيث تم ترويضهم على محاكاة نماذج عابرة، مما أضعف من قدرتهم على مواجهة التحديات الحقيقية.
أما فيما يخص وعي المجتمع بمستجدات العصر، فيبدو أن الغياب صارخ، مما ينذر بأخطار عدة، مثل النزعات الانفصالية والفجوة الطبقية. إنهم “أحياء” الحاضر السقيم الذين قد يورثون خرابًا لجيل ولد “معاقًا”.
الملحمية والأسطورية: عوائق في وجه العصرنة
أمة تحيط بها الأخطار من كل جانب، وهي غارقة في سكر الماضي البالي، تتأرجح وكأن العالم من حولها خاوٍ، وعقارب الزمن واقفة لا حراك بها.
لا يمكن أن تغيب عنك هذه الحقيقة المرة عندما تصطادك حبائل “مجالس الشاي” في كل فضاء يفترض أنه للعمل والإنتاج. تسحبك محادثات مبتورة من هموم الحاضر المتخلف وتحدياته الخطيرة، لتجد نفسك مبللاً بماء الأحاديث قبل أن تحملك أمواج هذا البحر العاتي إلى فضاءات العجب وأوهام تضخم الذات.
لا بد أن تُذعِن لحكم الإحساس المدغدغ، مُدركًا، إن لم تكن من سليل الحواشي والهوامش، أنك المعني بقصص الفروسية التي تتلألأ في معترك الحِمى، وبقرقعة السيوف وصهيل الخيول، ورغاء الجمال، وصوت الحابل مختلطًا بصوت النابل. تشعر بشغف عارم يملأ الآذان، وأنت تستعيد الفتوحات العلمية الباهرة التي انتشلت المشرق، حينما كان العلم نادرًا والمعرفة مهملة، في عصور اندثرت فيها قوة التجديد والجهود الراقية.
تبدو الكرامات كستار واقٍ، تعفيك من جهد العمل والكفاح، ملحمية وخرافية وميتافيزقية. لو كانت هذه القصص بعيدًا عن حقل العمل والإنتاج، لوجدت لها صدى أو قبولًا في السياقات الثقافية المتعددة، ولكان لها دور إثرائي. لكنها، كما هي، تُعد عوائق وكوابح تُعمق حالة التأخر وتفاقم الضياع، مُسهمًا في اتساع الشروخ واختيار الأسوأ.
فهل ننتبه ونعدل البوصلة قبل فوات الأوان؟ هل نُحظر “مجالس الشاي” المشحونة بنواقض العمل والإنتاج والإبداع؟