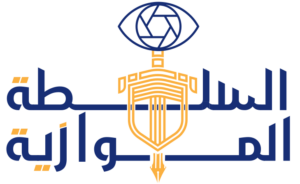القضية في جوهرها ليست تعصبا دينيا أو انحيازا مذهبيا بقدر ما هي انعكاس لنمط نفسي وفكري معين يحكم سلوك بعض الأفراد؛ فهؤلاء لا يتعصبون لشيء بذاته، بل يتنقلون بتعصبهم من ساحة إلى أخرى بحسب طبيعة الصراع القائم، فعندما يكون التدافع على المستوى العالمي بين الأديان تراهم يرفعون راية الدفاع عن الدين، وحينما يتحول التدافع إلى ساحة مذهبية داخل الإسلام، ينقلبون إلى مدافعين شرسين عن المذهب الذي ينتمون إليه؛ سواء كانوا سنة أو شيعة، وإذا غابت التعددية المذهبية، كما هو الحال في موريتانيا أو في مكان آخر
يتحول ولاؤهم إلى المكون العرقي فيتعصبون للعرب ضد المكونات الأخرى. وعندما تُختزل الساحة في العرب -أو في الناطقين بالعربية حتى لا يتعصب أحدهم- وحدهم، يظهر تعصبهم الداخلي، فيصير “الآخر” هو الحراطين، وإذا اقتصرت الساحة على شريحة واحدة -كالبِيظان- وتوهم واهم أن لضيق الرؤية حدودا؛ تجلى التعصب في صورته الجهوية ثم القبلية.
هذا النمط من البشر لا يعيش نشطا إلا في أجواء الصراع والتمييز؛ فطريقتهم في التفكير لا ترى العالم إلا من خلال ما يُميزهم عن غيرهم، لا ما يجمعهم بالآخرين، وهم في الحقيقة لا يحتاجون إلى المحاججة بقدر ما يحتاجون إلى المعالجة؛ لأن المشكلة أعمق من أن تُحلّ بالحوار اللهم إن كان حواراً مع محلل نفسي؛ فهي مرتبطة بجذور نفسية وثقافية ضاربة في أغوار الوعي والسلوك.
لقد لخص المفكر نعوم تشومسكي هذه النزعة البشرية حين قال -أو نُقل عنه- ما معناه:
“حتى لو اختفت كل الفروقات الدينية والعرقية واللغوية بين الناس، لوجد البعض سببًا آخر للتعصب، كأن ينقسموا بين من يكتبون باليد اليمنى ومن يكتبون باليسرى.