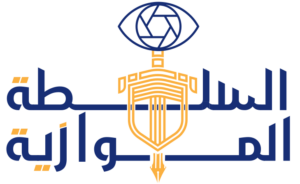عرفت الأستاذ محمد ولد أحمد ولد الميداح، قبل كثيرين ممن عرفوه لاحقا، أديبا وكاتبا وإعلاميا ومثقفا من طراز رفيع، فقد عرفته منذ أمد بعيد في قاعة الدرس، في طفولتي الأولى في المرحلة الابتدائية.
كان معلمي للغة الفرنسية أو “مسيي”، كما كنا نطلق عليه رهبا ورغبا، وبقي كذلك في عيني.
كان أول “مسيي” في حياتي، فقد درستني قبله سيدة اللغة الفرنسية، وحتى بعد ما عوض مدرستنا للغة العربية التي تغيبت لأسباب لا أعلمها في أحد الأيام، فلم تتغير الصورة!
ورغم أننا تفاجأنا في ذلك الصباح البعيد، بانقلاب “المسيي” إلى “سيدي” بسهولة لافتة، فقد فاجأنا نطقه للغة الضاد التي كنا نحسبه – بينا اتبهليل – لا يعرفها!!
وما زال في أذني صوته، وهو يضبط بأناقة وأناة، نطق الكلمات، وهو يرددها أمامنا، قارئا نصا عنوانه بقي معي حتى اليوم “بيتنا القديم”..
وربما لذلك بقي الأستاذ بالنسبة لي في “بيتنا القديم”، مدرستنا الأولى، مدرسة “فولانفاه” المعمرة والعريقة في “مذرذرتنا” المشتركة والحبيبة والبعيدة، وهي واحدة من أقدم مؤسسات التعليم في البلاد!!
وحين انتقلت لاحقا للتعليم العالي، ثم الحياة المهنية، وألحت علي الحاجة للاستخدام شبه اليومي للغة الفرنسية، وجدت أني قد حزت الأساس اللغوي، فقد كانت دروس النحو والصرف والتصريف وغيرها من القواعد الأساسية التي درسني إياها المرحوم في السنتين الخامسة والسادسة ابتدائية تكفيني من كل ذلك.
ولا أبالغ حين أقول إني بقيت بالنسبة للأستاذ محمد رحمه الله، ذلك التلميذ، الجالس بارتباك أمامه فجر الثمانينات، حتى بعد أن تحركت بنا جميعا عجلة الزمن، ودرات الأيام لأقابله في سياقات مختلفة، مسؤولا كبيرا في قطاع الثقافة، وأديبا ألمعيا، وإعلاميا مرموقا، واستشاريا محنكا.
ولذا لم أستطع أن أحاوره بحرية، حين كنت ألتقيه أيام توليه مسؤوليات في قطاع الثقافة، وفي مناسبات لاحقة، فقد كنت أجدني في حضرته ذلك التلميذ الجالس أمام معلمه!
وكنت أترك له حرية الحديث بعد سؤال واحد مرتبك في البداية، ولم يكن هو يخيب أملي، فيسترسل بجزالة وتمكن نادرين.
أذكر أنه دخل علي ذات يوم، وأنا في بهو أحد الفنادق مع مسؤول يمني، يشارك في تظاهرة ثقافية، وكنت قد طرحت على الضيف اليمني، وقت دخول المرحوم، وهو يومها مدير الثقافة، سؤالا عن المشتركات بين الشعبين، فتدخل بأدب، وقال لنا:
– من يرى سحنتيكما الآن، يدرك عمق المشتركات بين الشعبين، فلا هو يستطيع أن يفرز – إذا لم تكن له سابق معرفة بكما – أيكما اليمني أو الموريتاني!
وقد استحسن المسؤول اليمني هذا التعبير، وقال لمحمد:
– لقد أحسنت التعبير عن تشابه الشعبين بكلمات قليلة ومركزة.
وأعتقد أنه جعل هذه الفكرة محور مداخلة سجلت في أحد أيام تلك التظاهرة الثقافية..
وكان يطريني ويشجعني – وهو المسؤول السامي والمثقف المرموق – حين نلتقي بحضور من لا يعرفون ما يربطنا من علائق وثقي، فيقول لهم، إني من أفضل من درسهم اللغة الفرنسية استيعابا للدروس.
وربما لهذا، لا أعتقد أني استطعت أن أخرج الأستاذ من عباءة المعلم والمربي والموجه، الحريص على الشرح والإفهام، وربما استعاض فقط في المراحل اللاحقة عن رسم الكلمات بخط مرتب متموج وفق نسق معين على السبورة، كما عرفته أول مرة، بإلقاء وحضور ومساهمات ثرية، في حقول شتى، تتنوع بتنوع مجالات ثقافة الأستاذ، وعلو كعبه، وتذهب بعيدا لتشرح للمتلقي ما يقصد التعبير عنه، بحرفية واتقان و”قبول”.
و”القبول”.. عنوان آخر مهم من عناوين حياة الرجل، فقد منحه الله القبول بين الناس، وكان محببا لدى كل من عرفوه، وكان محترما في كل الأوساط التي احتك بها، ويكفيه شرفا أنه خرج من كل هذه الدنيا العاصفة بالعداوات والخصومات الكبيرة، والحزازات التافهة والصغيرة، دون أن يناله شيء من ذلك، ولم يهتم به، وبقي نقي القلب والعرض، يحترمه الجميع، ويجلونه ويقدرونه، ويختلفون في كل شيء، وربما لا يتفقون إلا عليه!
من كل هذه المحطات التي مر بها المرحوم، لم تلتصق بذهني من حياته سوى صفة المعلم “مسيي”، ويشفع لي – مع فارق المقام من جهتي – أن السياسي والدبلوماسي والأديب الكبير محمد عبد الله ولد الحسن رحمه الله، كان ينادي معلمه الأول، الإداري المرموق المرحوم سيدي أحمد ولد اياي، حتى آخر أيامه بـ”مسيي”، وكانت صفة المعلم لصيقة كذلك بكثيرين بصموا تاريخ البلد والعالم، فهذا زعيم تنزانيا، الذي قادها نحو الاستقلال “جوليوس نيريري” يلقب بـ”معلمو”، وهي كما هو واضح تصحيف للكلمة العربية – وبالمناسبة تحمل إحدى قاعات مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا اسمه، وهذه الصفة تسبقه، بوصفه أحد الآباء المؤسسين للاتحاد – وهي تعني المعلم باللغة السواحيلية، وهذه اللغة، هي خلاصة لغات وثقافات متعددة، كما كانت “مذرذرتنا” منذ القديم موئلا لتلاقح وتلاق ثقافي وحضاري، جسده، عبر القرون، لقاء ثقافتي المحصر واستدمين – وكان الراحل الكبير أحد فرسانهما كما يعلم الجميع- ومثله لاحقا، حي المدينة القديم “ملغاش” الذي يفقد برحيل محمد، واحدا من آخر العارفين بتاريخه، ورمزية المدينة كلها، ومنطقة “إكيدي” وخصوصيتها الثقافية، وما مثلته منذ قرون من عناق رائع بين السيف والقلم، وصياغتها لمنظومة قيمية متفردة.
رحم الله فقيدنا الكبير، الأستاذ محمد ولد أحمد ولد الميداح، “مسيي”، معلمي، ومعلم أجيال كثيرة من الموريتانيين، عرفته في الأقسام، وفي قاعات الدرس، وفي ميدان التأطير التربوي والإشراف الإداري، وفي المحافل الثقافية وعلى المنابر العلمية وعبر وسائل الإعلام.