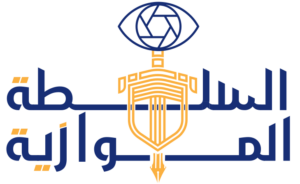في نهاية أغسطس 2006، أي قبل سبعة عشرة عاماً من الآن، رحل عن عالمنا الأديبُ الروائي الشهير نجيب محفوظ الذي كان وما يزال الأديب العربي الوحيد الحائز على جائزة نوبل. مَن منا لم يتعلَّم تاريخ مصر وعالمها الثقافي والاجتماعي من روايات نجيب محفوظ التي سلطت أضواء الشهرة على حارات وأحياء القاهرة القديمة، وجسدت بكل قوة الروحَ المصرية العريقة؟ ولا تختلف روايات الكاتب السوداني الراحل الطيب صالح عن هذا المنحى، فهو الذي كشف عن عالم القرية السودانية الساحر من خلال شخصيات مصطفى سعيد وود الريس والزين.. إلخ.
لا أحد لا يعرف شعر أبي القاسم الشابي الذي جسَّد الشخصية التونسية، وقد خلّدت كلماتُ إحدى قصائده الشهيرة في النشيد الوطني التونسي: إذا الشعب يوماً أراد الحياة…فلا بد أن يستجيب القدر.. في جل بلداننا العربية لدينا مثل هذه الشخصيات الأدبية، مثل بدر شاكر السياب في العراق، ومحمود درويش في فلسطين، وإبراهيم الكوني في الصحراء الليبية، وأحمدو ولد عبد القادر في موريتانيا.. إلخ.
كل هذه الأمثلة تدل على أن الأدب أكثر قدرةً على الكشف عن الشخصية الحضارية للمجتمعات والأمم من الأعمال النظرية من كتب تاريخ ودراسات اجتماعية وانتروبولوجية. ذكر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أنه عندما قرأ في شبابه رواية توفيق الحكيم «عودة الروح» أثّرت فيه بقوة، إلى حد أنه تقمص شخصية البطل الموعود الذي سيحرر البلاد وينصف الفقراء والمظلومين، وكان هذا من أسباب حركة 23 يوليو 1952.
ما تعلمناه من أدب توفيق الحكيم ونجيب محفوظ عن المجتمع المصري وثقافته أكثر فاعلية وتأثيراً من كتابات المفكرين من أمثال عالم الجغرافيا والاجتماع جمال حمدان الذي كتب أربعة مجلدات رصينة وموسوعية عن شخصية مصر. وحتى المفكر المغربي المعروف عبد الله العروي اعتَبرَ أن كتبه العميقة في تاريخ المغرب والوطنية المغربية تحتاج إلى أن تنقل إلى عالم الإبداع والخيال الروائي، فكتب روايات «اليتيم» و«الغربة» و«غيلة».. إلخ، وسلك مسلكَه المؤرخ البارز أحمد التوفيق في رواياته التي تركزت حول الشخصيات الصوفية في المجتمع التقليدي المغربي.
منذ ثمانينيات القرن الماضي شُغلت الساحة الثقافية العربية بسؤالين محوريين: سؤال العالمية المتعلق بشروط وصول الأدب العربي إلى دائرة المنافسة العليا في الحقل الثقافي الكوني، وسؤال الالتزام، أي هل يتعين على الكاتب أن يكون حاملاً لتطلعات وقضايا مجتمعه أم يكفيه تحقيق متطلبات الإبداع بغض النظر عن مضامين كتاباته؟ السؤال الأول حُسم عملياً، بعد أن ظهر أن الطريق إلى العالمية يمر بالمحلية، فالكاتب الناجح هو الذي يقدم أجواءَ مجتمعه الخاص إلى القارئ وفق شروط ومقتضيات الإبداع الرفيع، كما هو شأن أدب نجيب محفوظ في رواية الحارة والطيب صالح في أدب القرية وإبراهيم الكوني في رواية الصحراء.. وقد حصل مؤخراً الكاتب التانزاني من أصول عربية «عبد الرزاق قرنح» على جائزة نوبل عن رواياته الموغلة في المحلية حول مجتمع زنجبار التقليدي.
أما الإشكال الثاني فله خلفياته الأيديولوجية المعروفة التي برزت مع رواية التنوير في القرن الثامن عشر وأدب الواقعية الاشتراكية والوجودية السارترية في القرن العشرين. وفق هذا التصور، لا بد أن يكون الأدب في خدمة القضايا الإنسانية والاجتماعية العادلة، ولا بد للمثقف أن يكون «حارس المعبد» ودليل الوعي في النضالات اليومية التي يخوضها الجمهور.
لقد أطلق الفيلسوف الماركسي الإيطالي أنطونيو غرامشي على مثل هذا الصنف من المثقفين «المثقف العضوي»، وهو الناطق باسم مصالح وتطلعات طبقته الاجتماعية وحزبه السياسي. بيد أن هذا النموذج من المثقفين انحسر في العقود الأخيرة، وظهر نمط آخر أطلق عليه الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو تسميةَ «المثقف الخصوصي» الذي يؤرّخ للحاضر ويفكر في عصره دون أن تكون له أوهام قراءة المستقبل والتغيير الاجتماعي الجذري.
عندما توفي في أغسطس 2008 الشاعر الفلسطيني محمود درويش، كتبتُ في تأبينه أنه لم يكن «شاعر القبيلة»، وقد كنتُ أعني أن الأبعاد الإنسانية والجمالية في شعره تخرجه من ضيق الأدب الدعائي والنضالي الذي لا يختلف في نهاية المطاف عن المنشورات التعبوية والخطب السياسية الممجوجة. وحاصل الأمر أنه لم يعد لمفهوم الالتزام في الثقافة والأدب معنى، إذ من البديهي أن الكاتب يفكر دوماً في مجتمعه ويحمل هموم عصره، لكنه ليس داعيةً ولا محارباً.